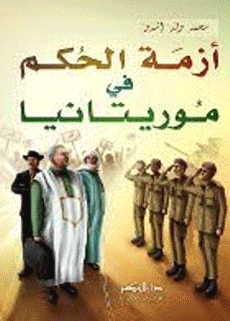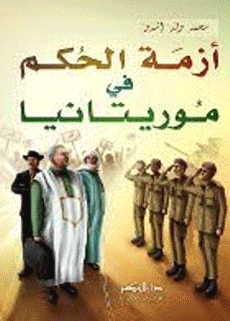نعيد نشر هذه المقابلة تأبينا لفقيد الأدب الشاعر محمد ولد عبدي رحمه الله
(ح2 / 3)
 في الحلقة الثانية من هذه المقابلة مع الشاعر والناقد الموريتاني وعضو اللجنة العليا لبرنامج أمير الشعراء د. محمد ولد عبدي وصف النقد الموريتاني بأنه قائم على المجاملة والتحيز لغير الإبداع، كما تحدث عن غربة يعيشها الشعر الموريتاني وأشياء أخرى في هذه الحلقة من هذا الحوار الصريح والجريء.
في الحلقة الثانية من هذه المقابلة مع الشاعر والناقد الموريتاني وعضو اللجنة العليا لبرنامج أمير الشعراء د. محمد ولد عبدي وصف النقد الموريتاني بأنه قائم على المجاملة والتحيز لغير الإبداع، كما تحدث عن غربة يعيشها الشعر الموريتاني وأشياء أخرى في هذه الحلقة من هذا الحوار الصريح والجريء.
سؤال: النقد الموريتاني متهم بالمجاملة والانتماء لغير الإبداع والخلق؛ لذا لم يستطع حتى الآن تقديم أية موهبة للجمهور.. وأنت الناقد هل توافق على هذه المقولة؟
جواب: لا بد في البداية من تحرير المفاهيم؛ فالمفاهيم - كما هو معلوم- معالمُ، إن اتضحت تجلَّى المعنى واستقامَ، وإن غمضت تعاظلتْ الدلالاتُ واستغلق الفهم؛ لذا فوصفك النقدَ بالموريتاني، قد لا أوافقك عليه؛ ذلك أن النقد علمٌ، له حدُّه وموضوعُه وفرضياتُه وآلياتُه، وهي خصائص وسمات تُحرره من التخصيص الجغرافي، حالُه في ذلك حال العلوم البحتة، مع الفارق في الدرجة؛ فهل يمكن الحديث مثلا عن فيزياء أمريكية أو كيمياء بريطانية أو رياضيات فرنسية وهلم جرا؟ لكننا يمكن أن نغير الصيغة ونتحدث مثلا عن هذه العلوم في تلك البلاد، فنقول الفيزياء في أمريكا أو الكيمياء في بريطانيا وهلم جرا، وعليه فإننا لا ينبغي أن نتحدث عن "نقد موريتاني" وإنما عن "النقد في موريتانيا" لأن العلم لا ينتمي، على عكس الفن الذي ينصبغ بخصوصياته السياقية؛ فيمكن مثلا أن نتحدث عن "الشعر الموريتاني" باعتباره شعرا تراشح مع سياقاته البيئية والثقافية والاجتماعية وتبادل معها التأثير والتأثر، وهو أمر قاربناه في كتاب "ما بعد المليون شاعر" ويمكن لمن يروم التفصيل أن يعود إلى ذلك الكتاب.
أما حكمك على هذا النقد بأنه قائم على المجاملة والتحيز لغير الإبداع، فهو أمرٌ أوافقك عليه، وإن من منطلق أشملَ يرتد -في نظري- إلى البنية العميقة لعقل إنسان تلك اليابسة وعلاقاته بآلية المجاز الذي يقوم عليه الشعر، وهو عقل - بطبيعة الحال- جزء لا يتجزأ من العقل العربي المُنبني على بنية البيان، كما أوضح ذلك المرحوم محمد عابد الجابري، ومعلوم أن البيان قائم على المجاز، والمجاز يُعَرَّف بكونه ضد الحقيقة، وعليه فقد تسرّبَ كلُّ ذلك إلى البنية الذهنية والمنظومة الأخلاقية والأنساق الاجتماعية، فأضحت كلها قائمة على المجاز، وهو حكم يتفاوت بطبيعة الحال من قطر عربي إلى آخر، حسب حظه من المدنية القائمة على قراءة الواقع برؤية حسية ملموسة، تتشيَّدُ في الأرض وليس في الخطاب اللغوي، كحال المجتمع البدوي الذي لا يؤمن بالسببية ويَحْكُمُ الانفصالُ رؤيتَه للعالم، وبهذا أبرر احتفاءَنا في موريتانيا المبالغ فيه بالشعر. ذلك أن أصدقَ الشعر - كما هو مقرر في النقد- أكذبُه، وعليه فقد تباهينا بأننا "بلد المليون شاعر" دون أن ندرك خطورة ما يتخفى خلفَ هذا الحكم، لهذا فلا غرابةَ أن يكون الخطابُ المشيّدُ على ضفاف الشعر عندنا يحكمُه النسقُ نفسُه المتخفي خلف الشعر، لأن النقد ما هو إلا خطابٌ على خطاب، وقسْ على مجازيتِه ومزاجيته و"كذبه الصادق" غيرَه من الخطابات؛ بل والمسلكيات السياسية والاجتماعية والدِّينية، ولا تحسبنَّ ظاهرتيْ "التصفيق" و"اللحلحة" تؤولان بغير هذا القانون الثقافي، فهناك إجماع ضمنيٌ بيننا على تبادل الكذب والنفاق الاجتماعي والسياسي والثقافي والدِّيني، وهو حكمٌ أدرك ما فيه من قسوة؛ ولكنه الواقع المتجرد من سحر "المجاز" وما لم نمارس النقد على ذواتنا وأنساقنا المضمرة فإننا سنظل نرسف في عمىَ ثقافي مقيت.
سؤال: الشعر الموريتاني قبل عقود كان يعيش غربة في وطنه ويهمل واقعه المحيط به بينما يصف واقعا آخر أقل التصاقا به؛ هذا ما يقوله الكثير من الشباب ما رأيكم؟
جواب: إن هذا الحكم النقدي صائب إلى حدٍّ كبير، وهو أمرٌ استشعرتُه شخصيا منذ الإرهاصات الأولى لتجربتي الشعرية وعملت على تجاوزه كما سأوضح لاحقا، كما عملت على تأويله نقديا، فإذا به يُخفي خلفَه نسقا ثقافيا نشأ مع ميلاد الدولة الوطنية تمثل في السَّعيِ إلى إثبات هوية مهددة من التخوم، ومشكك فيها من الأقربين، فعمل الشعراءُ والمثقفون منذ ذلك التاريخ على إثبات التماثل مع ما أسميتُه بـ"الشاهد الأمثل" في المشرق العربي، فعاش الشاعرُ رؤيةً ولغةً وتجربةً في تلك البيئة منسلخا من كينونته الزمانية والمكانية، وخصوصيته التاريخية والاجتماعية، وظل المثقفُ ينافح من أجل إثبات ذلك التماثل الذي يرى أنه لا يقتصر على المكونات البشرية وحسب؛ وإنما يتجاوزه إلى المكونات البيئية، مما جعل تلك التجربة تفرض نفسَها على الشاعر الموريتاني القديم والحديث وتقترحُ عليه رموزها وأساليبها في التفكير والتعبير، غير أن هذه الخصوصية مع تجاوز عقدة الانتماء وتراكم تجارب شعرية وطنية وازنة بدأت تختفي شيئا فشيئا.. خصوصا مع تزايد إكراهات الواقع المحلي وميلاد ثقافة جديدة هاجسة من مختلف التحولات الإقليمية والدولية.
سؤال: الجسر الذي سيوصلنا إلى العالمية ينطلق حتما من المحلية, هل يمكن للأدب الموريتاني أن يصل إلى العالم العربي والعالم بمفردات واقعه المحلي وخصوصيته الثقافية لكونه همزة وصل بين إفريقيا والعالم العربي؟
جواب: سؤالك هذا يحمل ضمنا إجابته، نعم إن الوصول إلى العالمية يمر - بلا شك- عبر جسر المحلية، وأعني هنا بالمحلية تشرُّب الأديبِ روحَ مجتمعه والاستغراقَ في واقعه لحدّ ملامسة مُشترك الذّاتِ الإنسانية فيه؛ فالقيم والمثل والمفاهيم مشتركاتٌ إنسانية، لكنها ترسو عميقا في الرُّوح، وتحتاج إلى حس مرهف شفيف قادر على اجتراحها بصدق وعمق واحتراف، أفليست مفاهيمُ كالحب والكراهية والحرية والقهر والحرب والسلام والعدالة والظلم مشتركات إنسانية عامة بأي لغة عُبِّر عنها، سيصلك معناها كما قاربه فنانٌ أو شاعرٌ أو روائي؟ إن محدوديةَ انتشار لغة ما أو الاستغراق في واقع محلي معين، لم يكن يوما عائقا أمام الانتشار العالمي، ولنا في الحاصلين على جوائز نوبل في مختلف اللغات دليل قاطع، أولم يستغرق غابرييل غارثيا ماركيث في الواقع الكولومبي المحلي، عبر قرية خيالية صغيرة تدعى "ماكوندو" في روايته "مائة سنة من العزلة" ورغم ذلك حصل - من خلالها- على جائزة نوبل للآداب، وترجمت إلى أغلب لغات العالم؟ إن الأدب الموريتاني قادر على الانتشار عربيا وعالميا إذا استطاع أن يتشرب روح واقعه ومجتمعه ويستثمر خصوصياته السياقية المتعددة التي تعتبر مصدر ثراء لا مصدر تخندق كما يحترف ذلك المتشربون للكراهيات الصَّفيقة، المقتاتون على وهم ذاكرة مشروخة ولغة محنطة خرساء.
سؤال: يلحظ المتتبع لكتابات الشاعر محمد ولد عبدي حضور الثقافة الوطنية بشكل كبير كمتكأ لتجربته الإبداعية؛ هل هذه المدرسة واسعة الانتشار في موريتانيا، وما موقفكم من الساحة الشعرية الموريتانية اليوم؟
جواب: حين بدأت تجربتي الشعرية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، تواكب ذلك مع انفتاحي على التجارب الشعرية في المشرق والمغرب العربيين، وعلى ما تيسر من تجارب شعرية فرنسية وإفريقية، كنت أشعر وقتها - وبحدس فطري- أن لكل مدونة من تلك المدونات خصوصياتها، وأن مشتركها لا يتجاوز حدّ جمال اللغة، وفي بعض الحالات النادرة تماثل الموضوعات. كانت تلك التجارب تمتعني لحدّ الحفظ، ولكنني لم أكن أجد فيها ذاتي مشاغبا يسعى إلى بصم خصوصيته الثقافية، كما بصمت هي ذاتها خصوصيتها السياقية المغايرة؛ بل إنني حين اطلعت على الشعر الموريتاني الفصيح - وخصوصا القديم منه- لم أشعر بأي علاقة حميمية بيني وبينه؛ اللغة كلها مستعارة، الأماكن مستعارة، حتى ولو ضمَّها الحيّزُ الجغرافي الموريتاني فإن تعريبها والصفات التي تُضفى عليها، تجعلها غريبة علي ومستعارة، الأخيلة مستعارة، الموضوعات – قديمها؛ بل وحديثها- مستعارة.. لهذا كله يممت شطر الشعر الشعبي "الحساني" ووجدت أن أصحابه أقرب إلي، وأنهم يتحدثون عن أشياء أعيشها، وأماكن أعرفها، وفقدٍ صادق أحسّه، فخضت في البدء تجربته وتشربته نصوصا، غير أنني، بحكم البيئة الثقافية والتكوين الأسري وحرص الوالد - رحمه الله- على تحقيقي لشروط الفتوة ودراستي عليه للقرآن ومتون اللغة والشعر؛ كلها أمورٌ رجّحت كفةَ الفصحى في مساري، وتمحضت تجربتي الشعرية لها، واعيا ضرورة بصم خصوصيتي الإبداعية، وتجسيد تجربتي الشخصية؛ متخذا عبارة استوقفتني لابن حزم ذات قراءة في "طوق الحمامة" دستورا شعريا، حيث يقول: "وما مذهبي أن أَنضِيَ مطيةَ سوايَ وأتحلَّىَ بحليٍ مستعارٍ" ظلت هذه العبارةُ مذهبي وما تزال. أقمتُ حوارا إبداعيا بين الفصحى والعامية، وجعلتهما يتراشحان في روحي، وطَّنت قصيدةَ الحداثة في موريتانيا، ومهرتُها بخصوصيتنا الثقافية قنطرةً بين حضارتين، وأعتقد أني - بذاك الصنيع- قد أضفت إلى الشعر العربي المعاصر سحنةً يفتقدها، ورفدتُه بماء بيئةٍ بكرٍ كانت - إلى عهد قريبٍ- غائبةً ومُغيبةً، لقد عملت على خلق رموز وطنية عمَّمتُ دلالتِها عربيا، وعلى اجتراح لغة خاصة لا تنتمي إلا إليَ خلاسيَ الرُّؤى والأحلام، وأعتقد أن تلك التجربة قد هاجرت إلى نصوص بعض الشعراء الشباب المبدعين وتشربوها وعيا كتابيا ما يزال في طور التَّخَلق ولكنه واعد ومبهج وفارق وأصيل.
(نقلا عن صحيفة "التبصير" الألكترونية)
http://ettabsir.info/?p=2525