| د. محمد عبدي: "أصعب الغربة وأعمقها ما كان في الوطن ذاته" |
| الأربعاء, 31 ديسمبر 2014 09:09 |
|
نعيد نشر هذه المقابلة تأبينا لفقيد الأدب، الشاعر محمد ولد عبدي رحمه الله (ح1 /3)
ضيفنا حمل الحرف المثور نضالا وقضية، وعرفته المنافي وعرفها في رحلته الطويلة لمناهضة التناقضات الاجتماعية التي يضج بها المجتمع الموريتاني.. كتب دواوين شعرية عديدة، وألف العديد من الكتب النقدية، ضيفنا هو الشاعر والناقد الدكتور محمد ولد عبدي
سؤال: يلاحظ المتتبع للدكتور محمد ولد عبدي ندرة حضوره في المشهد الأدبي الموريتاني - خاصة في وسائل الإعلام- خلال فترة التسعينات، فما هو مرد ذلك؟ جواب: أولا أبارك لكم هذا الموقع الذي نتمناه "تبصيرا" ثقافيا فارقا يزيل الغشاوة والعمى الثقافي والفكري عن بصر وبصيرة هذا المجتمع المقهور والمسحور؛ المقهور بفعل التاريخ والجغرافيا وما خلقا من ندرة تحكمت في مصائر القوم تدبيرا وتعميرا، والمسحور بفعل ثقافة نسقية تلقينية تَتَغيا التبريرَ في التفكير والتعبير، مما يحتاج بالفعل إلى تبصير يكشف تلك الغشاوات ويُعيد للناس وعيَهم في لحظة فارقة من التاريخ الوطني. أما بخصوص سؤالك عن غيابي الإعلامي في عقد التسعينيات، فأنت ربما تعرف سياقات تلك المرحلة وإكراهاتها وطنيا؛ فلقد اتسمت بتصنيم السلطة والتهافت عليها، وتشييء القيم وامتهانها، وسقوطِ القناعات الأيديولوجية وتكشفِ أقنعةِ ذويها.. مما دفعني – مُجبرا- إلى الهجرة، اتقاءً للسُّقوط في وحل ذلك الواقع النَّكِد المتدني، الذي تمرغ فيه الساسةُ والمثقفون دون حياء، وتهافت فيه الشعراءُ والكتابُ على القصر الرمادي متأبطين المجازَ عساهم به يقتاتون.. دونما شعور منهم جميعا بأنهم همْ من خلق من السلطة طاغوتا، وهم من رفعوا أعلامَ قبائلهم وجهاتِهم وفئاتِهم عاليةً على سارية العلم الوطني، فأجهزوا على ما تَبقَى من وطنٍ هشاشتُه في المنشأ بادية، فهل لي وقد حملتُ هذا الوعيَ أن لا أتحملَ تبعات تبنيه؟ ذاك ما كان. اغتربتُ مخافةَ أن يذكر التاريخُ لكم - وللذين سيولدون- أني اشتركتُ في صناعة طاغية أو إيقاظ نعرة منتنة، أو تبدلتُ بالانتماء الجمعي ولاء ضيقا لا وطناً يُبقي ولا حلمًا يُحققُ، هكذا آثرتُ الصمتَ الإعلامي – محليا على الأقل- في تسعينيات القرن الماضي، لأن من يتكلم في تلك الحقبة لا بدّ أن يَتحدثَ لغةَ التهليل والتبجيل، ولسانَ "الولاء" و"البراء" وتلك شِنشنةٌ لا إخالني خُلقتُ لها. ورغم ذلك ففي التسعينيات - وبفضل المأمن في الحياة والأمن في التفكير اللذين توفرا لي في الإمارات العربية المتحدة مشكورة- استعطت أن أُصدر مجموعةَ كتب ناطقة بالذي أتغياهُ شعرا وفكرا، فكان ديوان "الأرض السائبة" وكتاب "ما بعد المليون شاعر" وكتاب "تفكيكات" وكتاب "فتنة الأثر" وغير ذلك مما صدر لاحقا في العقد الأول من هذا القرن.
سؤال: أنتم أحد المهتمين بالتناقضات التي يعيشها المجتمع، وتحاربونها بالحرف والفكر منذ عقود، فهل تعتقدون أن هذه التناقضات ما زالت "تسافر في الشخوص" كما قلتم في أحد آخر نصوصكم "شقاق الطين"؟ جواب: إن ما تسمونه هنا بالتناقضات المجتمعية (وأسميه بالأمراض النسقية) هو ذاكرةٌ موشومةٌ أسسها الزمنُ الثقافي في إدارته التاريخية للمجتمع عبر طلبه لِمَزِيَّتَيْ المعاش والتعايش وإكراهات كل منهما، مما يُولِّد بالضرورة صراعا على امتلاكهما، تتمركز بموجبه سلطةٌ تحتكرُ إدارتهما، وتولدُ بمقتضاه هوامشُ تتفاوت في الإقصاءِ حسب حظها من تلك السلطة وجودا أو فقدا، وهذا قانونٌ عام يسري على كل المجتمعات، ويتفاوتُ حضورُه وهيمنتُه فيها بحسب كسبها من المدنية وحظها من بناء الدولة؛ ذلك أنه كلما استغرقت مجتمعاتٌ ما في البداوة شحَّ عيشُها واحتدم الصراع على استملاك الموجود منه، وبالتالي صعُب تعايشها (بل واستحالَ) لأن لكل منها سرديتَهُ التاريخية وأسطورته التأسيسية وفضاءَه الرمزي وحيزَه التداوليَ، وهي أمور من منظوره تعطيه شرعية الاستحواذ والتملك والاحتكار؛ وبالتالي تُكسبه سلطةً يحسبها لن تدوم له وتستقيم إلا بنفي الآخر وتهميشه وشَيْطَنَته، مُستدعيا عند الضرورة مواردَ ذاكرته الموشومة، أما في المجتمعات المدنية المنتظمة داخل الدولة الحديثة فإن المعاشَ والتعايشَ محكومان بقانون عام يحتكم إليه الجميعُ ويتساوى أمامه الجميعُ، لا يشعر فيه الإنسان بأي تناقضٍ بين ما هو جديرٌ به وبين ما هو عليه في الواقع المعيش، على عكس المجتمعات المتخلفة التي تتحدد فيها مصائرُ الأفراد قبل الولادة، لا حسب الكسب والكفاءة والعطاء، وذلك مكمن الأمراض النسقية التي أشرتَ إليها في سؤالك، وهو ما عليه الحالُ في وطننا العزيز موريتانيا، وهو كذلك ما علينا جميعا أن نقاومَ، ونعمل على تجاوزه، لأننا إن لم نبادر وندرأَ هذا الاختلالَ الصَّارخَ وتلك الأمراض النسقيةَ التي "ما زالت تسافر في الشخوص" عبر المسلكيات الخاطئة، والرُّؤية العمياء والتجاهلِ الغَبي لما يجري بوتيرة متسارعة في واقعنا اليومي المأزوم، فإننا يوشك أن نرمي بمصيرنا المشترك في بحرٍ من العنف الأعمى لا قدر الله؛ ليس لنا به من قبلُ قبيلٌ، وساعتها كما في قصيدة "شقاق الطين" التي أشرت إليها: لا جبلٌ يقيِ أحداً ولا سُفُنٌ ولا مرسىَ فهل غدُنا سنسلمُهُ لكفِّ الريح؟
على كل منتمٍ إلى تلك الأرض وذاك المجتمع -أيٍا كان تموقعُه أو تحيزُه- أن يعمل على درء إقراره أو تقريره، عبر رفض كل ما من شأنه أن يوصلنا إلى الهاوية، ولن يكون ذلك إلا بمكاشفة الذاتِ وفضحِ حيل الأنساق ومكرها الفائق وقدرتها على المخاتلة والتخفي وتغيير المواقع. وأحسبُ أن لكل منا إمكاناته الكامنةَ في بناء غدٍ يسع أحلامنا جميعا، وتأسيسِ وطنٍ يتسع لنا جميعا، فكلنا - مظلومٌ وظالمٌ- عيالُ الله، وكلنا في ذلك المنتبذ تلاحقنا إكراهاتُ التاريخ وجراح الجغرافيا.
سؤال: المنفى أحد المفردات التي لا يمكن ذكر الشاعر الدكتور محمد ولد عبدي إلا وقفزت إلى الذهن, لماذا هذا الاغتراب، وهل أفادتكم الغربة؟ جواب: المنفى هو وجودٌ عتبيٌ ناقصٌ، يتمزق صاحبُه بين فضاءين، وطنِ الولادةِ الذي لفظه ووطنِ الإقامة الذي لم يتملكه؛ ورغم ذلك ففيه من كليهما وجودٌ، وله في كل منهما قدمُ صِدقٍ، إنه يقف على العتبة بينهما في منطقة مأزومة، ما عاد يتملك الأول الذي ظلّ في تدنيه ينحدر قِيَمًا وأحلاما، وعيشا وتعايشا، ولا هو امتلك الثاني، وجودا غير منقوص، وإن احتضنه كأحسن وِفادَةٍ، ولكن إلى حين. هكذا المنفى وقوف على عتبة بين وجودين، ينفثان في الشاعر روحَ الحنين إلى وطن مُتخيل يجمع مشتركات الوجودين، ويقاربهما في نصوص تفضح سرَّ الهوية وكينونتَها؛ إذ ليست الهويةُ وجودا مُعطى كما رّوجَ لها المبلسون أصحاب الأيديولوجيات الصماء، وظنوها قدرا تشكَّل قبلَ الولادة، أو هي جوهرةٌ مكنونةٌ في نقطة ما من التاريخ ضاعت، وعلينا استعادتها، معتمدين قياسَ الشاهد على الغائب؛ وإنما هي وجودٌ يتشكل باستمرار، ويُكتسب باستمرار، ويُراجع باستمرار، ويُنتقد باستمرار.. هكذا تتجدد الحياة، وهكذا يعمل المخلصون للإنسان من أجل أن لا تنغلق الحدودُ وتتعطل اللغة بينه وبين أخيه الإنسان. ذاك – عزيزي- هو فهمي المتواضع للمنفى ورؤيتي الحؤول للهوية. أما لماذا المنفى فهو سؤالٌ يحرك الكثير من المواجع والعديد من المواجد؛ فالغربةُ - أيها الشاعر الجميل- ليست بالضرورة مرهونة بالمَهَاجِر؛ إنما أصعبها وأعمقها وأعقدها ما كان في الوطن ذاته! وهو معنى أشار إليه من قبلُ شيخُنا أبو حيان التوحيدي قدس الله سره، وهو ذاتُه ما كنت عشتُه أنا بين ظهراني ذلك الوطن المقهور والمهدور، لذا اخترت – مجبرا- أن أهاجر، مخافةَ سقوط الضّمير، والغدر بالشاعر داخلي، وخيانة من تشبثوا بي حلما يُشام. وأنا في ذلك على سنة خير البرية حين سنّ الهجرةَ، وعلى درب صاحبنا الشنفرَى حين أوصانا مَعشرَ الشعراء أن "في الأرض منأى للكريم عن الأذى". أما هل أفادتني الغربة، فالجواب بَدَهيٌ بلا شك، نعم أفادتني على صُعُد شتى؛ أفادتني بأن دَرأَتْ عني السقوطَ في وحل الأحكام المتلاعنة في وطني المسلوب، ولم أركن إلى أي منها رغبا أو رهبا، وأفادتني بأن أطعمت أبنائي حلالاً، لا شِيَةَ فيه من حقٍ عام أو خاص، مَردَ "المستأمنون" في وطني على استحلاله وهو جهنمُ ذاتُها؛ إذ كفَى بالمقهورين هناك يَتامىَ، وأفادتني الغربة ثالثا أن فتحت لي عوالمَ إنسانية عديدة، أدركتُ من خلالها أن الإنسان خَيِّرٌ بطبعه، إذا اعترفتَ بوجوده ولم تنفه، وأن إدارةَ الهويات المتعددة أمرٌ ليس بالمستحيل على الإطلاق، وكفى التجربة الوحدوية المتميزة في الإمارات العربية المتحدة دليلا على ذلك، حيث أزيد من مائتي جنسية وافدة غير متجانسة تعايشت كلها في أمان، وأُديرت بحكمة وحنكة، رسم خطوطها العريضة المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وأخيرا استفدتُ من الغربة أن راكمت تجاربَ ونصوصا ومعارفَ ما كنت لأحصل عليها لو لم أهاجر وتتسع رُؤايَ وتنفتح على جهات العالم المختلفة. (نقلا عن صحيفة "التبصير" الألكترونية)
|
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
الآن في المكتبات
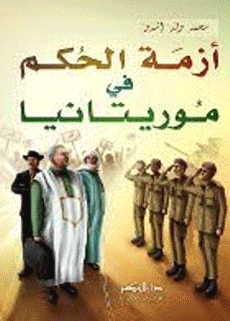
 في إطار المساعي الرامية إلى تحريك ساحة راكدة لحد الموت السريري قررنا في "التبصير" القيام بسلسلة حوارات ومقابلات مع شخصيات ثقافية وفكرية وازنة في المشهد الموريتاني والعربي
في إطار المساعي الرامية إلى تحريك ساحة راكدة لحد الموت السريري قررنا في "التبصير" القيام بسلسلة حوارات ومقابلات مع شخصيات ثقافية وفكرية وازنة في المشهد الموريتاني والعربي