| إلى رفاقي فقط |
| الجمعة, 18 نوفمبر 2016 07:19 |
|
اشريف ولد الشيخ
وإنما أردت ان أسوقها في مدخل هذا التوضيح الذي أتقدم به حول تصريحاتي ومواقفي الأخيرة التي أثارت بعض الجدل؛ خصوصا في أوساط أصدقائي من اليسار الموريتاني الذي لا أتنكر له انتماء، وإن كنت أدافع عن موقعي ضمنه بحسب التحولات الفكرية والسياسية التي مررت بها في السنوات الماضية. إن دوافع هذه الأسطر ليست جوابا بقدر ماهي محاولة لمراجعة فكرية فكّر العبد الضعيف كثيرا قبل نشرها. ولا بد أن نتفق في البداية حول معنى اليسار الذي لا يفهمه الكثيرون إلا باعتباره خروجا عن تقاليد المجتمع وثقافته ودينه وقيمه، مع أنه يعني في دلالته الحقيقية رفض الظلم والغبن والاضطهاد والتفاوت الاجتماعي، والانحياز لقضايا المستضعفين، والرهان على حركة التاريخ والمستقبل؛ وهي معاني لا تحتكرها منظومة فلسفية بعينها أو أيديولوجيا سياسية محددة، بل تتعلق بتطلعات ومثل إنسانية عليا لكل ثقافة منها نصيب. هذه المثل التنويرية الرحبة هي التي وجدها "لاهوت التحرير" المسيحي في أمريكا اللاتينية في الأوساط الكاثوليكية، وهو كما صاغه الراهب "غوتريز" تحويل موضوع الإيمان بالله الى محور نظرية العدالة الاجتماعية بالانحياز للفقراء الذين هم عيال الله وملح الأرض، ووقوف المؤسسة الدينية ضد الاستغلال والاستبداد. أليست هذه المعاني أقوى في الاسلام دين العدالة والرحمة الذي وعد المستضعفين بالتمكين في الارض وتوعد المستكبرين الظلمة الذين "لا يحضون على طعام المسكين" بالخسار في الدنيا والأخرى؟ تلك هي المعاني التي انطلق منها الروائي والكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي في كتابه الرائع "محمد رسول الحرية " الذي خصصه لسيرة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ووجدها الفيلسوف الإيراني علي شريعتي في خلفائه وصحابته من نوع الامام علي كرم الله وجهه وسلمان وابي ذَر. أسوق هذه المقدمة لأصل منها إلى أني وإن انتميت مبكرا لليسار وناضلت بكل تجرد وحماس في صفوف حركة "ضمير ومقاومة" وقبلها حركة "الديمقراطيين المستقلين" وعانيت مصاعب المنفى، وحرمت سنوات من مضارب الأهل ووجوه الأحبة، فاني لم أعتقد يوما من الأيام ان أهداف وتطلعات الشباب اليساري المشروعة يمكن أن تتحقق إلا في إطار ثقافة المجتمع وتقاليده، وإلا ظلت مستهجنة غريبة لا منفذ لها في القاعدة العريضة المتمسكة بدينها وقيمها. كانت تجربة حركة الكادحين التي ظهرت في الستينيات ماثلة امام أعيننا؛ وهي الحركة الشبابية الرائدة التي حملت هموم وتطلعات المجتمع في النهوض والتقدم، وحققت كثيرا من أهدافها النبيلة، لكنها وصلت في نهاية المطاف الى الوعي بضرورة التخلي عن القوالب الماركسية من أجل التجذر في المجتمع والتأثير فيه. لقد أدركت أنا وعدد من زملائي هذه الحقيقة بهذه المراجعات التي قمنا بعد سقوط نظام ولد الطائع الذي حاربناه طويلا، وبعد الانفراج الديمقراطي الذي عرفته البلاد بعد انقلاب 2005 والحركة التي تلته عام 2008، منطلقين من حقائق أربع رئيسية: أولا ضرورة الانتقال من طبيعة العمل السري الذي فرضته علينا ظروف قاهرة إلى العمل السياسي العلني ضمن قوالب الشرعية المتاحة، بعد أن أُزيلت كل القيود المضروبة على العمل السياسي، ولم تعد الأحزاب عرضة للحل والمنع كما كان الشأن سابقا. السلوك الديمقراطي الصحيح يقتضي - من هذا المنظور- ممارسة النشاط السياسي بحسب قواعد اللعبة الشرعية باحترام قوانينها وأخلاقياتها كما هو الحال في كل الديمقراطيات المستقرة العتيدة. ثانيا ضرورة الانتقال من مثالية الثورة إلى واقعية النضال الليبرالي. الثورة حلم جميل يتشبث به المظلومون والمقهورون، ويكون قوة محركة للمجتمع في لحظات انسداد الأفق وغياب الأمل، لكنه نادرا ما يفضي الى نتيجة ملموسة، وقد قيل إن الثورة يصنعها الحالمون ويموت فيها الأبطال ويستفيد منها الجبناء الانتهازيون. وفي كل الأحوال لا معنى للثورات عندما يصبح التغيير ممكنا بالوسائل الديمقراطية السلمية ما دام ثمن الثورة - كما تدل التجربة التاريخية- هو أنهار من الدماء والدموع. ثالثا الانتقال من المثالية الحالمة إلى الواقعية الملتزمة. المثالية موقف أخلاقي نبيل، لكنه عقيم ومدمر، وقد قال أحد الفلاسفة متهكما من أخلاق الفيلسوف الألماني كانط إن يده نظيفة لكن لا يد له! أما الواقعية فإذا لم تكن محافظة على موقف أخلاقي ومبدئي فإنها تتحول انتهازية وارتزاقا، وذلك ما لا يقبله المناضل الملتزم الذي يعرف إكراهات الواقع وحدود الإمكانات المتاحة فيتحرك ضمنها دون أن يتخلى عن مبادئه وقيمه وأفكاره. رابعا ضرورة الانتقال من الموقف العدائي الراديكالي لأنظمة الحكم دون تمييز أو تمحيص إلى موقف موضوعي يراعي التفريق بين الأنظمة القمعية الاستبدادية التي لا بد من الخروج عليها ومحاربتها بالوسائل الديمقراطية والأنظمة التي تحترم قواعد الشرعية الديمقراطية وتتبنى الحوار والانفتاح، وتصون الحريات العامة وحقوق الانسان؛ وبذا تكون أهلا للدعم والتأييد والتعاون. إن هذه المتطلبات هي التي كانت وراء مواقفي الاخيرة الداعمة لخط الحوار والإصلاح الذي تبناه الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وقد راعيت في التزامي السياسي أمورا ثلاثة: تعميق التجربة الديمقراطية التي تحتاج دوما للتوحيد والتحصين، وقد تحققت فعلا خطوات وإنجازات مهمة في هذا المجال؛ من بينها نتائج الحوار الأخير الذي شاركت فيه مع بعض أصدقائي السياسيين. الدفاع عن الثوابت الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني في مواجهة الدعوات العنصرية والفئوية التي لا مكان لها في دولة المواطنة القائمة على المساواة. دفع نهج التقدم الاجتماعي وتحديث المجتمع وتنويره. كان الزعيم الفرنسي الكبير الجنرال ديغول يقول إن الناس تعتقد عادة أن مبدأ السياسة هو النجاعة لا الأخلاق؛ متناسين أن النجاعة في السياسة قد تكون في الالتزام الاخلاقي.. تلك هي الخلفية السياسية التي أصدر عنها في أفكاري ومواقفي، وهي التي كانت خلفية توجهاتي الحالية في دعم التوجهات الإصلاحية للرئيس محمد ولد عبد العزيز دون أن أشعر بأي تعارض مع ضميري الاخلاقي. عاشت الجمهورية وقيم الجمهورية. موريتانيا أخرى ممكنة. Une autre Mauritanie est possible.
|
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
فيديو
الآن في المكتبات
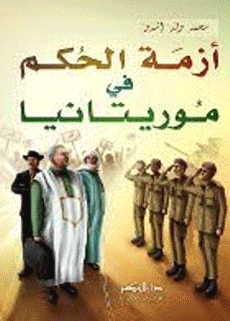
 "إن من لا يكون مثاليا في سن العشرين لا قلب له، ومن يظل بعد الثلاثين لا رأس له" تعزى هذه العبارة لسياسيين عديدين ليس هذا مجال التعرض لهم.
"إن من لا يكون مثاليا في سن العشرين لا قلب له، ومن يظل بعد الثلاثين لا رأس له" تعزى هذه العبارة لسياسيين عديدين ليس هذا مجال التعرض لهم.